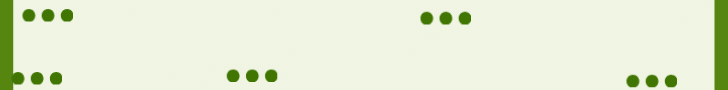«الأصل والأثل والتوحيد»… البحث عن منشأ الحضارة والدولة
ألفه ثلاثة مختصين ويعتمد على البحوث الأثرية واللغوية

يعتمد كتاب «الأصل والأثل والتوحيد… البحث عن الحضارة والدولة واللُّغة والديانة الأولى في المشرق الأدنى القديم» على البحوث الأثرية (الأركيولوجية) واللُّغوية، لمؤلفيه، من جامعة لوسيل بالدوحة د. عامر عبد الرزاق ضفَّار، ود. لبنى ناصر الدين، ومدير مركز «فامر» بإسطنبول الباحث أحمد معاذ يعقوب أوغلو.
يقع الكتاب الصادر حديثاً عن دار «الآن ناشرون وموزعون» في الأردن في 558 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمسة فصول للدكتور عامر ضفار منها نصيب الأسد، إذ إنه مؤلف الكتاب ما عدا الفصل الرابع، الذي يتكوَّن من مبحثين طويلين، أحدهما للدكتورة لبنى، والآخر لأحمد معاذ أوغلو.
يركز الكتاب منذ الفصل الأول على مركز الوجود البشري، أو بتعبير الدكتور ضفار «الحضارة الأم» وليس الإنسان، مشيراً إلى أول دولة مدينة نشأت في التاريخ، ومؤصلاً لتاريخ اللغات السامية، وأيها كانت الأسبق، كما يتوالى البحث خلال فصول الكتاب عن نقاط التلاقي بين اللهجات السامية، وكذلك الفقه المقارن بين اللغة العربية واللغات الهندو – أوروبية بفروعها، سواء الإنجليزية والفرنسية واللاتينية، أو التركية والفارسية والكردية، كما يتعرَّض أيضاً للديانة الأولى (العقيدة الأم) لمصر والعراق والشام.
ويقول الدكتور ضفار في مقدمة الكتاب: «واستند هذا الكتاب إلى المصادر التي اعتمدت على علم الآثار واللغة والبحوث المحكّمة، واعتمدنا المنهج الوصفي النظري التحليلي للمصادر والنصوص، بالإضافة إلى المنهج المقارن التاريخي واللغوي والتلاقي اللّغوي من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة داخل المتن».
ويرى وفقاً لعدد من المؤرخين وعلماء الاجتماع أن «العمران» جاء من المشرق، ومن ثم انتشر في ربوع العالم، وهذا ما دعاه للتركيز على حضارة ولغة تلك المنطقة (المشرق)، الذي يشمل مصر والعراق والشام بشكل جوهري، مع عرض بعض الحضارات القديمة المعاصرة لتلك الحضارات.
وألمح الدكتور ضفار في الفصل الأول إلى بدايات العمران في العالم، معرِّجاً على عصور تكوُّن طبقات الأرض، ثم بدء الزراعة وتربية الحيوان، ومن ثم اللبنات الأولى في تكوُّن الحضارات.
ويحاول الكتاب الإجابة عن التساؤل القديم المتجدد: أين نشأت أقدم حضارة على وجه الأرض التي نعيش عليها؟ فهل يحسم البحث والعرض والتحليل جواباً شافياً؟ وهناك افتراضات من مصادر متنوِّعة حول كون جميع اللغات الإنسانية تعود في أصلها إلى لغة جزيرة العرب الأولى، وهذا أحد الموضوعات الأساسية التي انشغل الكتاب بدراستها، كما أنه راح يبحث ويحلل في أصل الكتابة، وما هي أقدم كتابة في العالم وأين؟ هل هي الكتابة المصرية أم السومرية؟ وهل الأقدم الأبجدية الأوغاريتية أم الكنعانية أم اليونانية؟
يتساءل ضفار في الفصل الثالث: «لكن ما اللّغة؟»، ليجيب: «إنّ اللّغة والكلام عندنا ليسا بشيء واحد، فإنّما هي منه بمثابة قسم معين وإن كان أساسيّاً، والحق يقال، فهي في الآن نفسه نتاج اجتماعي لملَكة الكلام، ومجموعة من المواضعات يتبنَّاها الكيان الاجتماعي ليُمكِّن الأفراد من ممارسة هذه الملَكة، وإذا أخذنا الكلام جملةً بدا لنا متعدِّد الأشكال متباين المقوِّمات موزَّعاً في الآن نفسه بين ميادين متعدِّدة بما فيها الفيزيائي والفيزيولوجي والنفسي، منتمياً في الآن نفسه إلى ما هو فردي وإلى ما هو اجتماعي، ولا يتسنَّى لنا ترتيبه ضمن أي قسم من أقسام الظواهر البشريَّة لأننا لا نستطيع أن نستخرج وحدته».
وفي المقارنة بين التأثيل والترسيس، يقول ضفار مستشهداً بآراء السابقين من علماء اللغة: «فالتأثيل هو ردّ الكلمة إلى أمّها المباشرة أو جدّتها المباشرة أو القريبة»، وأما الترسيس فهو: «إعادة اللفظة إلى جدّتها الأولى – حوّاء – في صورتها التي نطق بها أوّل إنسان، مع تعقّب المراحل التطوُّرية التي قطعتها تلك اللفظة حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها بها الآن في إحدى اللغات».
وفي المبحث الأول من الفصل الرابع تناقش الدكتورة لبنى ناصر الدين الفقه اللغوي المقارن بين اللغة العربية الفصحى واللغات الهندو أوروبية الغربية، خصوصاً الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.
تقول الدكتورة لبنى: «ظهر الاهتمام بالعلاقة بين اللغات السامية عموماً، والعربية خصوصاً، واللغات الهندية الأوروبية في وقتٍ مبكّرٍ من تاريخ الدراسات اللغوية المقارنة، حينما اتجهت المدرسة التاريخية في القرن التاسع عشر إلى تحليل اللغات على أسسٍ صوتيةٍ وصرفيةٍ بهدف إثبات القرابة اللغوية، وقد تميّزت تلك المرحلة بجهودٍ سعت للمقارنة بين اللغات الجرمانية والرومانسية من جهة، واللغات السامية من جهةٍ أخرى، دون الوصول إلى نتائج حاسمة».
وتستشهد بأمثلة تطبيقية، إذ يمكننا أن نعدَّ هذا الفصل بمبحثيه الجزء التطبيقي في الكتاب، لكثرة الشواهد والأمثلة التطبيقية التي يزخر بها.
وتختتم المبحث الأول قائلة: «وفي المجمل ما زالت هذه المقارنة تتطلّب دراساتٍ أعمق ومعاجم أوسع ووسائل تقنيةٍ أكثر تطوّراً، فضلاً عن ضرورة دراسة السياقات الحضارية التي صاحبت نشوء هذه اللغات وتطوّرها، ومن شأن هذا المسار البحثي أن يعزِّز فهمنا للتاريخ اللغوي العالمي، وأن يبرز مكانة اللغة العربية بين اللغات الكبرى، ويعزِّز حضورها في الساحة الأكاديمية والثقافية».
يأتي المبحث الثاني من الفصل الرابع بعنوان «في الفقه اللغوي المقارن بين اللغة العربية الفصحى واللغات الشرقية (الكردية والتركية والفارسية)»، وهو من تأليف أحمد معاذ يعقوب أوغلو، ويبدأه قائلاً: «إنّ ما يُطلق عليه اليوم (اللغة) هو (اللسان)، وما يُطلق عليه اليوم (اللهجة) هو (اللغة). أما المحكيات ضمن كل لغة فهي ما يلهج به أهل تلك البقعة، فهي اللّهجات، وما زلنا نقرأ أن هذه الجملة على لغة هذيل، وأن تلك الكلمة على لغة تميم… وكفى بالقرآن شاهداً ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾، لكن سترد اللّغة بمعنى اللسان كثيراً في هذا البحث جرياً على العادة».
ويقارن أوغلو بين تلك اللغات ويستشهد بأمثلة تطبيقية منها جميعاً، موضحاً أن اهتمامه في هذا المبحث: «مقارنة اللّغة العربية الفصحى مع ثلاث لغات تنتمي إلى عائلتين مختلفتين، وكلتاهما تختلف عن العائلة التي تنتمي إليها العربية، ومع ذلك فقد كانت هناك مجالاتٌ تحوي مساراتٍ تتوازى بها العربية مع واحدة منها أو أكثر، ومساراتٍ أخرى تتقاطع العربية فيها مع لغةٍ من لغات البحث أو أكثر».
أما الفصل الخامس فركز فيه الدكتور ضفار على «الديانة الأولى» في منطقة الشرق القديم: مصر والعراق والشام، ليخلُص إلى أن ديانة التوحيد قديمة قدم الإنسان في كل الحضارات القديمة، سواء استطعنا الاستدلال على ذلك، أم توصَّلنا إليه بشواهد العلم والعقل والمنطق، والشاهد الأقوى هو أن جميع الحضارات القديمة قد عرفت التوحيد وتركت آثاراً تدلُّ عليه، مؤكداً ذلك بقوله: «الديانة الأولى للحضارات القديمة في المنطقة هي التوحيد، وليس صحيحاً ما يُشاع غير ذلك».
- عمَّان: : «الشرق الأوسط»
![]()